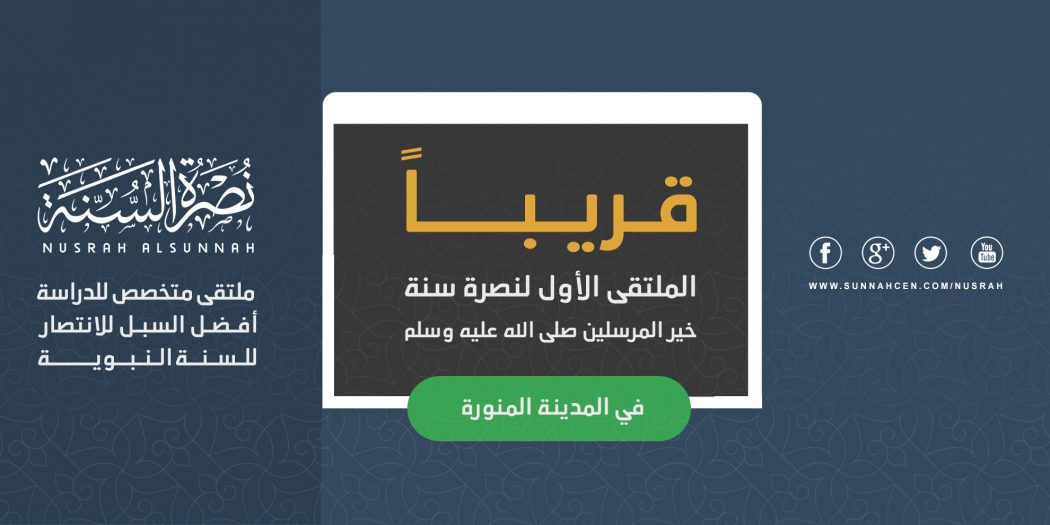المقدمة:
المتأمل في شبهات أعداء الإسلام بشتى مذاهبهم وطوائفهم وأصنافهم يلحظ أنهم كثيرًا ما يجنحون إلى تلطيخ الإسلام وأحكامه وشرائعه بما في أولئك الأعداء أنفسهم من قبائح ومستشنعات ومعايب ومتناقضات، فالملحد الذي لا يكاد يملك لفكره حجة صحيحة يصم الإسلام بأنه دين خرافي من اختراعات المتدينين وكأنه لا حجة عليه! والمستشرق النصراني الذي لا يشك أن كتابه المقدس قد نالته أيدي التحريف (أو التهذيب والتذييل على حد زعمهم) يزعم أن نصوص الوحي الإسلامي قد نالته أيدي خفية وتلاعبت به، والحداثي الذي لا يكاد يفصح عن مقصوده بلسان مبين يزعم أن نصوص الوحي غير مترابطة وغير متسقة! وهذا هو الإسقاط الذي نتحدث عنه في هذه الورقة[1].
ومن يتتبع الشبهات المثارةَ حول السنة النبوية التي اخترع كثيرًا منها المستشرقون([2]) يجد أنهم أصرُّوا على اصطحابها معهم وهم خارجون من ديارهم وأديانهم وتواريخ كتبهم المقدسة، وأسقطوها على فصول النص النبوي وأبوابه، فركبوا بحر الإسلام الهادئ الصافي بأساطينهم الحربية التي يواجهون بها بحار كفرهم وتحريفات المحرفين وأساطير المكذبين والقصص والمسائل الهائجة المتلاطمة الأمواج، ويقودون زورقهم بما اعتادوه في بحارهم من الفجاجة والصّلافة، متعامين كلَّ العمى عن طبيعة البحر الإسلامي الرائق، فهم يحاولون أن يلبسوا السنة النبوية ما التبست به نصوص كتبهم المقدسة، وينبزون رجال الحديث بما نُبذ به قساوستهم ورهبانهم الأوائل، ويقحموا ظروف كتابة نصوصهم في ظروف كتابة السنة النبوية، وإن اختلف الرجال عن الرجال والأحوال التاريخية عن الأحوال التاريخية.
فهؤلاء قد شطت بهم أقلامهم إلى التلبيس على السنة بما يخجل منه وجه الحقيقة وتحمر له وجنة الصدق، إنه عمًى منهجي في البحث العلمي، وكفى بهذا الوصف عارًا لهم وشنارًا، وكفى من ينعق بنعيقهم عيبًا، فذلك العيب المنهجي كان جاريًا على أقلامهم، فشوهوا وجه الحقيقة وسوَّدوا جبين الإنصاف، وقد رصد منهجهم الفجّ جملة من الباحثين([3]).
ولذا كانت هذه الورقة لتناوُلِ هذا العيب المنهجيّ في شبهات السنة النبوية، وإبراز إسقاطات أوائل من أثار الشبه حولها من المستشرقين، وهو ما فيه معتبر لمن تأثر بشيء من تلك الشبه من المسلمين، ومرتدع ومنتَقد لمن يردِّد شبه أولئك دون أن يعرف أصولها.
ويقتصر دورنا في هذه الورقة على بيان وجه الإسقاط في الشبهة؛ مكتفين بمن سبقنا بالرد عليها في أبحاث أخرى، وطالبين التركيز والاختصار في هذا البحث.
تمهيد:
منذ بدءِ الإسلام وبزوغ فجر دين الحق تراجعت اليهودية والنصرانية، وبدأت حصونها في السقوط حصنًا بعد حصن، ودخل الناس في دين الله فرادى وأفواجًا، وقريةً بعد قريةٍ، حتى وصل نور الإسلام أراضي فرنسا، واقتنع به واعتنقه جملةٌ كبيرة من العقول اليهودية والنصرانية البارعة، وجنَّ جنون أولئك وقامت قيامتهم وحاروا حيرة ما بعدها حيرة، كيف لدينٍ كدين الإسلام أن يتَّسع كلَّ هذا الاتساع في وقت وجيز، ويُقنع كلَّ هذه الأعراق والألوان من البشر؟! وبدل أن يكون هذا الأمر معجزة وداعية إلى التفكير في حقيقة الدين الإسلامي واعتناقه ثارت فيهم حمية العصبية، وأبوا إلا أن ينافحوا عن معتقدات آبائهم ويتَّبعوا آثارَهم، فبات الإسلام مشكلةَ المشكلات لدى اليهود والنصارى في أوروبا؛ فهو العائقُ والحاجز المنيع دون انتشار أديانهم وأفكارهم، وهو الخطر الحقيقيُّ الذي سيبيِّن بطلان فكرهم وعقائدهم، ومن هنا هبُّوا وانطلقوا مذعورين؛ فبذلوا كلَّ وسيلة لحماية دينهم ومواجهة الدين الإسلامي، ومعرفة مكامن قوَّة المسلمين وأسرار انتشار دينهم وانتصارهم التي لم تكن سهلة المنال بطبيعة الحال([4])، وشنُّوا الحملات الصليبية، وأرسلوا البعثات الاستشراقية التي لم تقتصر على نشر الشبهات والإشكالات عن الدين الإسلامي فحسب، بل كما قال القائل: لم يتركوا سوأةً ولا آفة ولا منقصة إلا وألزقوها بالإسلام وأصوله([5])؛ محاولين تشويهَ صورته وزعزعة اليقين في الدين الإسلامي وبلبلة المنظومة العقدية الإسلامية الرصينة وهزِّ كيان مصادرها كالقرآن والسنة، ولكن هيهات، فالإسلام يحمل في ذاته الطبيعة النورانية الذهبية التي لا تنطفئ ولا تتغير ولا تنطمس وإن تعرَّض لمحاولات التشويه والإحراق؛ بل هي كفتنة الذهب إذا أدخل الكير، كلما اشتدت مِحَنه برزت محاسنُه، وازداد بريقه ولمعانه، وأنبأك عن صفائه وجودته أكثر وأكثر، يقول ابن تيمية (728هـ) رحمه الله: “ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهورُ المعارضين لهم من أهل الإفك المبين، كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ} [الأنعام: 112، 113]، وقال تعالى: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} [الفرقان: 30-32]؛ وذلك أن الحق إذا جُحِد وعورض بالشُّبُهات أقام الله تعالى له مما يحقُّ به الحقَّ ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من أدلة الحقِّ وبراهينه الواضحة، وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة، فالقرآن لما كذَّب به المشركون، واجتهدوا على إبطاله بكل طريق مع أنه تحداهم بالإتيان بمثله، ثم بالإتيان بعشر سور، ثم بالإتيان بسورة واحدة، كان ذلك مما دلَّ ذوي الألباب على عجزهم عن المعارضة، مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب، ولو اتَّبعوه من غير معارضة وإصرار على التبطيل لم يظهر عجزهم عن معارضته التي بها يتم الدليل… وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا، إذا أظهروا من حججهم ما يحتجّون به على دينهم المخالف لدين الرسول، ويموِّهون في ذلك بما يلفِّقونه من منقول ومعقول كان ذلك من أسباب ظهور الإيمان الذي وعد بظهوره على الدين كلِّه بالبيان والحجة والبرهان، ثم بالسيف واليد والسنان… فالدين الحقُّ كلما نظر فيه الناظر وناظر عنه المناظر ظهرت له البراهين، وقوي به اليقين، وازداد به إيمان المؤمنين، وأشرق نوره في صدور العالمين، والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل، ورام أن يقيم عودَه المائل، أقام الله تبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وتبين أن صاحبه الأحمق كاذب مائق، وظهر فيه من القبح والفساد والحلول والاتحاد والتناقض والإلحاد والكفر والضلال والجهل والمحال ما يظهر به لعموم الرجال أن أهله من أضل الضلال، حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد، ويتَنبَّه بذلك من سنة الرقاد من كان لا يميز الغي من الرشاد، ويحيا بالعلم والإيمان من كان ميتَ القلب لا يعرف معروفَ الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين”([6]).
ومما سبق يظهر لنا شيء من الدوافع والمنطلقات التي ينطلق منها المشروع الاستشراقي، ولا عجب بعد ذلك أن نسمع أن من أساليبهم الإسقاط الذي تحدثنا عنه، يقول المستشرق (رودي بارت) عن المستشرق (ريموند لول) -المتوفى في 1316م-: “وكانت له جهود كبيرة في إنشاء كراسي لتدريس اللغة العربية في أماكن مختلفة؛ وكان الهدف من كل هذه الجهود في ذلك العصر وفي العصور التالية هو التنصير، وهو إقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام واجتذابهم إلى الدين النصراني”([7]). ويقول المستشرق (لورانس): “إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرًا، وأمكن أن يصبحوا أيضًا نقمة له، أما إذا بقوا متفرِّقين فإنهم يظلُّون حينئذ بلا وزن ولا تأثير”([8]).
فلا نستغرب بعد هذه الأهداف أن ينزع المستشرقون إلى الإسقاط كأحد الوسائل لنصر الإسلام، فما الإسقاط؟
الإسقاط -كما يقول أحمد عزت راجح في أصول علم النفس- هو: “ملاحظة السلوك الظاهر للغير من إنسان وحيوان وتأويله على أساس من خبراتنا الشعورية نحن… وهو منهج يفترض أن الغير يشعرون كما نشعر، ويفكِّرون كما نفكر، ويسلكون كما نسلك نحن لو وجدوا في نفس ظروفنا”([9]). وقد عدَّه إحدى الحيل الخداعية عند الأزمات النفسية في كتابه، وضبط تعريفه بقوله: “حيلة لا شعورية تتلخَّص في أن ينسِب الإنسان عيوبه ونقائصه ورغباته المستكرهة ومخاوفه المكبوتة التي لا يعترف بها إلى غيره من الناس أو الأشياء أو الأقدار أو سوء الطالع… وذلك تنزيها لنفسه وتخفُّفًا مما يشعر به من القلق أو الخجل أو النَّقص أو الذَّنب”([10]). فبالإسقاط يحكم المرء على نفسه مع أنه في الظاهر يحكم على غيره، ويعترف بشناعاته وعيوبه، بينما هو في الظاهر ينسبها إلى الآخرين([11]).
ويعرفه أسعد رزق بأنه: “تفسير الأوضاع والمواقف والأحداث بتسليط خبراتنا ومشاعرنا عليها، والنظر إليها من خلال عملية انعكاس لما يدور في داخل نفوسنا… فهي حيلة نفسية يلجأ إليها الشخص كوسيلة للدفاع عن نفسه ضد مشاعر غير سارة في داخله، مثل الشعور بالذنب أو الشعور بالنقص، فيعمد -على غير وعي منه- إلى أن ينسب للآخرين أفكارًا ومشاعر وأفعالًا حياله، ثم يقوم من خلالها بتبرير نفسه أمام ناظريه”([12]).
ومما سبق نستطيع أن نلاحظ ما يلي:
- أن الدافع إلى الإسقاط هو الشعور بالنقص والدونية لدى القائم به.
- أن الغاية من الإسقاط الدفاع عن عيوب أو نقص في القائم بها.
- أن إجراء عملية الإسقاط يتم لا شعوريًّا.
- أن الهدف الذي يتمّ توقيع الإسقاط عليه غالبًا يكون منزَّهًا عمَّا يوجَّه إليه من خلال عملية الإسقاط([13]).
هل رصد الباحثون الإسقاطَ في مناهج المستشرقين؟
إذا نظرنا بعدسة البحث العلمي الموضوعيّ وجدنا جملةً من الباحثين قد رصدوا هذا المنهج في العقول الاستشراقية، وعلى سبيل المثال يقول الدكتور عبد العظيم الديب وهو يستعرض مناهجهم فيذكر منها: “التفسير بالإسقاط: ونعني بهذا إسقاط الواقع المعاصر المعيش على الوقائع التاريخية الضاربة في أعماق التاريخ، فيفسرونها في ضوء خبراتهم ومشاعرهم الخاصة وما يعرفونه من واقع حياتهم ومجتمعاتهم… ومن طرائف التفسير بالإسقاط ما رأيناه عند المستشرق الإنجليزي (مونتجومري وات) إذ فسر ما كان من خلوة الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء قبيل البعثة بأنه كان هروبًا من حر مكة وابترادًا في رأس الجبل جبل حراء؛ حيث كان محمد صلى الله عليه وسلم فقيرًا لا يستطيع السفر إلى الطائف مثل أغنياء قريش… إن السبب في هذا التفسير العجيب الغريب هو تصور واقع الصيف والمصطافين في عصرنا هذا: نفقات ورحلات وسيارات وفنادق… إلخ”([14]).
ويقول أ. د. محمد أمحزون وهو يصف حالهم في تعاطيهم وتناولهم لقضايا الدين الإسلامي: “إن المستشرقين في كثير من الأحيان يحكمون على الإسلام والتاريخ الإسلامي معتمدين على قيمهم ومقاييسهم الثقافية الخاصة، بدلًا من الاعتماد على المصادر التاريخية وأعراف ومبادئ المجتمع الإسلامي، ولا شك أن مصدر الخطأ في منهجهم هو التدخل بالتفسير الخاطئ للأحداث التاريخية وفق مقتضيات وأحوال عصرهم الذي يعيشون فيه، دون أن يراعوا ظروف العصر الذي وقعت فيه الحادثة، وأحوال الناس وتوجهاتهم في ذلك الوقت، والعقيدة التي تحكمهم ويدينون بها. وبصرف النظر عن الحقد والتعصب لديهم يمكن القول بأن سبب انحراف منهجهم ومن اتبعهم في هذا الطريق هو القياس الفاسد”([15]).
ويقف بنا الدكتور مازن مطبقاني على شيء من هذا الإسقاط في أحد النماذج الاستشراقية وهو المستشرق (برنارد لويس) حيث يقول: “التقط بعض الأفكار التي تعود إلى الثقافة الرومانية التي تمثل جذور الفكر الأوربي الحديث والمعاصر، كما تأثر الفكر اليهودي المسيحي الأوربي بالثقافة اليونانية الرومانية، وقد أشار لويس في حواره مع الباحث إلى دراسته للتاريخ الروماني والبيزنطي على يد المؤرخ المشهور باينيس (Baynes)، والذي استفاد منه تطبيق منهج دراسة الإمبراطورية الرومانية على دراسة الخلافة العباسية، ويلاحظ عموما تأثير هذا المصدر الفكري على لويس في دراسته للمجتمع الإسلامي بتقسيمه إلى عدة طبقات كما هو الحال في دراسة المجتمع الروماني والأوربي الوسيط، وهي طبقات الأرستقراطية وعامة الشعب والعبيد، وإذا نظر لويس إلى معاملة الإسلام للمرأة -ومن ذلك التعدد- نظر إليها نظرة الأوربي الحديث الذي يرى في ذلك امتهانًا وحطًّا لشأن المرأة، وعندما يتحدث لويس عن التشريعات فإنه يعود إلى تاريخ روما والضرائب التي كانت تفرضها على الشعوب الواقعة تحت احتلالها”([16]).
نماذج من إسقاطات المستشرقين:
وهنا حان الوقت لتسليط الضوء على بعض الشبهات التي تعامل فيها المستشرقون بهذا المنهج، منتهجين منهج الاختصار، فبعض الربيع ببعض العطر يختصر، فمن أهم إسقاطاتهم:
- دعوى أن النص الحديثي ملفق اخترعه الرواة من أنفسهم؛ لتأييد آرائهم ومذاهبهم واجتهاداتهم الفقهية، وتوثيقا لها نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوى أنها شريعة الله المنزلة على محمد.
طعن المستشرقون في مرويات بعض الصحابة؛ بدعوى أنها أكثر عددًا من مرويات الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم خلال أيامه الأولى، فمثلًا عدد الأحاديث التي رويت عن الخلفاء الأربعة هي أقل بكثير من الأحاديث التي رواها أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يتوقف طعن هؤلاء المغرضين بالصحابة الكرام واتهامهم بوضع الأحاديث بل تجاوزه إلى العلماء المسلمين قاطبة من السلف الصالح، ومن هذا قول (جولدتسيهر): “ولا نستطيع أن نعزو الأحاديث الموضوعة للأجيال المتأخرة وحدها، بل هناك أحاديث عليها طابع القدم، وهذه إما قالها الرسول، أو هي من عمل رجال الإسلام القدامى”([17]).
وأيضًا المستشرق (شاخت) حيث ادعى أن الأسانيد الحديثية مجرد تزويق لرفع مدى اعتماد الحديث لا أكثر، يقول: “إن أكبر جزء من أسانيد الأحاديث اعتباطي… ومعلوم لدى الجميع أن الأسانيد بدأت بشكل بدائي، ووصلت إلى كمالها في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري… وكانت الأسانيد كثيرًا ما تلصق بأدنى اعتناء… وأي حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات ويضعها في الإسناد، وفي الأمثلة التالية نجد مظاهر الاعتباط في الأسانيد وانعدام الثقة فيها”([18]).
وهكذا يدَّعي المستشرقون أن الفقهاء وعلماء الدين متعاونين مع السلطة الحاكمة كانوا يشرِّعون القوانينَ ويسنّون الأنظمة والدساتير وفقا لما توصلهم إليه اجتهاداتهم، ووصل بهم الحال أن اخترعوا وسيلة من الوسائل لتوثيق آرائهم وتأييدها، وهي نسبتها إلى السابقين والأوائل من التابعين والصحابة حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم اعتمادها وجعلها جزءًا من الشريعة الإسلامية، وهي في الحقيقة ليست سوى الطقوس والعبادات والتشريعات المتفق عليها بين المجتمع آنذاك، هكذا يزعم المستشرقون!!
يقول (شاخت) أيضًا: “وفكرة الاستمرار الموروث في تصور السنة والعمل المثالي مع الحاجة إلى إيجاد بعض المبررات النظرية لما كان متبعًا حتى الآن بكونها آراء الأكثرية لممثلي المدارس الفقهية والتي ترجع إلى أوائل عقود القرن الثاني قادت تلك الجماعة المتخصصة إلى نسبة ذلك وإرجاعه إلى فترة زمنية متقدمة، وهذا ما تعنيه بقولها: (الأمر المجتمع عليه) في المدارس الفقهية، ونسبته إلى بعض الشخصيات الكبيرة في الماضي. وكان الكوفيون سباقين في نسبة نظرياتهم إلى إبراهيم النخعي، وتبعهم في ذلك المدنيون فيما بعد في هذا المجال. وعملية قذف الآراء إلى الماضي لإيجاد أساس نظري للفقه الإسلامي… لم توقف على شخصيات متأخرة نسبيًّا، بل توغلوا في نسبتها إلى الماضي أكثر فأكثر حتى وصلوا إلى نقطة بداية الإسلام في الكوفة حيث أُشرِك ابن مسعود في هذا العمل. أما حركة المحدثين في القرن الثاني فهي في الواقع نتيجة طبيعية لاستمرار حركة المعارضة للمدارس الفقهية القديمة، والتي كانت متأثرة بالدين والأخلاق، والفكرة الرئيسية التي كانت عند المحدثين هي أن الأحاديث المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تغلب على سنن المدارس الفقهية، ولهذا الغرض اخترع المحدثون بيانات مفصلة أو أحاديث، وادعوا أنها من مرئيات أو من مسموعات أقوال النبي وأفعاله وتقريراته، وأنها وصلت إلينا شفهيًّا بأسانيد غير منقطعة، وعن طريق رواة موثوقين”([19]).
عجيب أمر شاخت هذا! فهل يظن أن الأحاديث النبوية قد جمعت في تابوت وأوكل حفظها إلى بعض المسلمين وعلماء الدين ثم لم يحافظوا عليها وضيَّعوها ليأتي بعد ذلك من يحاول استرجاع الأحكام الإسلامية وكتابتها ومحاولة إضفاء الشرعية عليها كما حصل مع كتابهم المقدس التوراة؟! أم يظن أن المسلمين عاشوا قرونًا من الاضطهاد والتشرذم كحال اليهود حتى عادوا بعد ذلك يدوِّنون ما بقي لهم من التشريعات محفوظًا ويحاولوا نسبته إلى سلفهم شيئًا فشيئًا حتى ينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل مع اليهود وتاريخهم مع كتابهم ونصوصهم المقدس؟!
نعم، نجد هذا الإشكال الذي نسبه شاخت إلى الأحاديث بعينه في التوراة، فإذا رجعنا إلى تاريخ التوراة وأسفارها نجد أن الحال التي ذكرها شاخت والقصة التي أطال في تنظيرها هي قصة توراتهم، فإن موسى عليه السلام كان قد غضب من قومه لإشراكهم بالله سبحانه وتعالى وعبادتهم العجل، فألقى الألواح التي بها التوراة فانكسرت، ولكن يذكر اليهود في كتبهم -وتحديدًا في التوراة وهذا من العجائب أن يذكر ما حصل للكتاب في نفس الكتاب- أن موسى عليه السلام قبيل وفاته بقليل كتب التوراة وعهد بها إلى حاملي التابوت المقدس ليحفظوها ويصونوها ويعملوا بها، ولكن ذلك ما لم يحصل، جاء في سفر التثنية: “وكتب موسى هذه التوراة، وسلمها للكهنة من بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب، ولجميع شيوخ إسرائيل، وأمرهم موسى قائلًا: في نهاية السبع السنين في ميعاد سنة البراء في عيد المظال حينما يجيء جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره، تقرأ هذه التوراة، أمام كل إسرائيل في مسامعهم”([20])، وجاء فيه أيضًا: “فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلًا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدًا عليكم؛ لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. هوذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحرى بعد موتى”([21]). وورد أن يوشع بن نون أيضا كتب التوراة على أحجار المذبح تنفيذًا لوصية موسى عليه السلام، وبعد هذا الوقت لا ذكر للتوراة في تاريخ اليهود، ولكن ورد ذكر ذلك التابوت، وأن أعداء اليهود قد استولوا عليه في عهد صمويل النبي، ثم استردوه بعد سبعة أشهر، وبقي في قرية يعاريم، حتى أخذه داود عليه السلام بعد عشرين سنة ووضعه في أورشليم، ثم وضعه سليمان عليه السلام في الهيكل الذي بناه، وكانوا يستقبلونه في الصلاة.
ولكن العجيب في الأمر أن التوراة التي كانت محفوظة في التابوت قد فقدت، ولم يجدها سليمان عليه السلام حين فتح التابوت! ولا أحد من اليهود والنصارى يعلم أين ذهبت النسخة الأساسية التي عهد بها موسى إلى آبائهم، وهذه معضلة المعضلات في تاريخ كتابهم.
وقد انقضَّ على بيت المقدس وملكِ اليهود ملكُ مصر آنذاك واستولى عليها([22])، ولم تشر كتب اليهود إلى حال التوراة والتابوت بعد ذلك إلا بعد ثلاثة قرون وأكثر، وذلك في عهد الملك يوشيا حيث يذكرون أنه وجد سفر الشريعة، وهناك أمر الملك بجمع شيوخهم وجميع الشعب وقرأ عليهم ما وجد([23]). وبغض النظر عن إمكانية أن يكون هذا هو التوراة حقًّا بعد كل هذه القرون، لكنها لم تسلم لليهود أيضًا، فبعد خمس وعشرين سنة تحديدًا عام (586 ق. م) هجم بختنصر الكلداني على دولة يهوذا ودمرها: “فأصعد عليهم ملك الكلدانيين، فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم… وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤسائه أتى بها جميعا إلى بابل، وأحرقوا بيت الله، وهدموا سور أورشليم”([24]).
ولا يختلف أحد من اليهود والنصارى أن ما كان بيدهم من الكتب فقد هنا مرة أخرى في هذه الحرب الضروس والتدمير العام!
ولكن اليهود يزعمون أن (عزرا الكاتب) قد التجأ إلى الله ونقَّى نفسه وطهَّر قلبه من الآثام([25])، وطلب شريعة الرب زمن السبي البابلي، وقد سمح لليهود بالعودة إلى بيت المقدس بعد ذلك زمن ملك الفرس، وجمعهم لقراءة ما كتب من شريعة موسى، واجتمع اليهود في ساحة، وطلبوا من عزرا أن يأتي بالتوراة ويقرأها، فجاء بها وقرأها من الصباح إلى نصف النهار([26])!
فأين وجد عزرا التوراة؟! أم كانت مجموعة من كتاباته وما عرفه من التشريعات والأحكام؟! أم كانت بعض عادات أهل المنطقة هي التي جمعت؟!
فمن الواضح هنا أن عزرا قد كتب لهم التوراة([27])، ولم يذكر اليهود من أين وصلت التوراة إليه وبينه وبين موسى عليه السلام أكثر من ثمانية قرون! فهي إما أن تكون مفتراة مكذوبة، أو يكون قد دوَّنها عزرا من محفوظاته وما وصل إليه من مدونات ومعلومات، وإما أن تكون أحكامًا متوارثة.
ليس هذا القول مجرد جرة قلم شخصية، بل هو منطق الباحثين في اليهودية من كل الأديان، يقول (ول ديورانت): “وإذا ما أنقصنا من قيمة الكتاب ما فيه من أساطير بدائية، ومن أغلاط مبعثها صلاح الكاتبين وتقواهم، وأقررنا أن ما فيه من أسفار تاريخية لا تبلغ من الدقة أو من القدم ما كان أجدادنا السابقون يفترضونه فيها، إذا ما فعلنا هذا كله فإنا لا نجد في الكتاب طائفة من أقدم الكتابات التاريخية فحسب، بل نجد فيه كذلك طائفة من أجمل تلك الكتابات… وأكبر الظن أن المزامير ليست كلها من وضع داود وحده، بل من وضع طائفة من الشعراء كتبوها بعد الأسر اليهودي بزمن طويل، ويغلب أن يكون ذلك في القرن الثالث قبل المسيح، على أن هذا البحث التاريخي كله لا يعنينا”([28]).
وقد تساءل (ول ديورانت) عن نشأة الأسفار المقدسة في اليهودية والنصرانية وكيفية نشأتها وعن كاتبها، وهل كتبها موسى عليه السلام أم هو قذف للنصوص إلى الأقدمين، فيقول: “كيف كتبت هذه الأسفار؟ ومتى كتبت؟ وأين كتبت؟ ذلك سؤال بريء لا ضير منه، ولكنه سؤال كتب فيه خمسون ألف مجلد، ويجب أن نفرغ منه هنا في فقرة واحدة نتركه بعدها من غير جواب. إن العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هما القصتان المتشابهتان المنفصلة كلتاهما عن الأخرى في سفر التكوين، تتحدث إحداهما عن الخالق باسم يَهوَه، على حين تتحدث الأخرى عنه باسم إلوهيم. ويعتقد هؤلاء العلماء أن القصص الخاصة بيَهوَه كتبت في يهوذا، وأن القصص الخاصة بإلوهيم كتبت في إفرايم، وأن هذه وتلك قد امتزجتا في قصة واحدة بعد سقوط السامرة. وفي هذه الشرائع عنصر ثالث يعرف بالتثنية أكبر الظن أن كاتبه أو كتابه غير كتاب الأسفار السالفة الذكر. وثمة عنصر رابع يتألف من فصول أضافها الكهنة فيما بعد، والرأي الغالب أن هذه الفصول تكون الجزء الأكبر من سفر الشريعة الذي أذاعه عزرا، ويبدو أن هذه الأجزاء الأربعة قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالي عام (300 ق. م). وكانت أساطير الجزيرة هي المعين الغزير الذي أخذت منه قصص الخلق والغواية والطوفان التي يرجع عهدها في تلك البلاد إلى ثلاثة آلاف سنة أو نحوها قبل الميلاد”([29]).
ويقول د. أحمد شلبي: “أما كتَّابها فكثيرون، ويبرز من بين الكتَّاب اسم الكاهن عزرا مرتبطًا بتدوين التوراة، ويذكر Hosmer أن عزرا هو الذي في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد قاد جماعة من اليهود إلى فلسطين؛ حيث استعاد بها الحياة اليهودية، وهو الذي أبرز أجزاء كثيرة مما سمي فيما بعد بالعهد القديم، وقد أكمل الكهنة الذين جاؤوا بعد عزرا ما بدأه هذا الكاهن… ويروي العلامة رحمة الله الهندي أقوال بعض المؤرخين الغربيين التي تقرر أن توراة موسى ضاعت، فأوجدها عزرا مرة أخرى بإلهام”([30]).
ويقول د. عبد الوهاب المسيري: “ويبدو أن مشادات فقهية بين الفقهاء كانت تحدث من وقت لآخر في شأن بعض الأسفار نظرًا لما تحتويه من أفكار غنوصية مثل سفر حزقيال، واتفقوا في نهاية الأمر على تركه داخل إطار الكتب القانونية مع عدم تدريسه للصغار”([31]).
وإذا عدنا إلى قول المستشرق (شاخت) وشبهته التي ألقى بها على السنة النبوية وجدنا أنها في الحقيقة مجرد إسقاط لما يعانيه من إشكال وهو يدرس تاريخ كتابهم المقدس أو نصوص علمائهم وأحبارهم وكهنتهم التي حاولوا أن يقذفوها كل فترة إلى فترات زمنية متقدمة؛ رغبة منهم في التوثيق لأقوالهم وآرائهم، وهو أمر طبيعي مع ما عاشته الأمة اليهودية من تكرار الاضطهاد والتشريد والهزائم المتتابعة والإبادات المتوالية، فحاول من حاول منهم أن يدوِّن ما يعرفه من الأحكام والتشريعات، وادعى أنها من التوراة، هذا ما حصل مع التوراة ولكن (شاخت) أسقطه إسقاطًا على السنة النبوية!
فأين سمع بأن المسلمين قد مرَّ بهم اضطهاد وإبادة وتدمير لدولتهم في قرونهم الأولى؟! ومن سمع من المؤرخين يدعي بأن علماء الحديث قد انتهوا وأبيدوا وكتبهم سرقت ودمرت في زمن من الأزمان؟! ألم يسمع بسِيَر رواة الأحاديث النبوية وبذلهم وتفانيهم في سماعها وحفظها وتداولها والعمل بها؟!
يبدو أن (شاخت) لم يسمع أو يتظاهر بعدم السماع أو أنه مصرٌّ على توجيه عيوب دينه وضلالات تاريخه على الدين الإسلامي، وإلا لما ادعى أن الأحاديث النبوية لم تكن موجودة في القرن الأول والثاني كما في الشبهة التالية.
فقد ظهر للقارئ الكريم المنهج الإسقاطي وكيف كان المستشرقون يبثون شبهاتهم وتشكيكاتهم حول السنة النبوية والدين الإسلامي عامة من رحم هذا المنهج في التفكير، وهو ما يدلنا على ضحالة كثير من تلك الأقوال في منطلقاتها، وقد فنَّد هذه الشبه والدعاوى من جذورها وأتى عليها من أصولها وفنَّد فروعها جملة من أهل العلم من المسلمين، ولكن العجب ممَّن يرددها في كل نقاش ويستحضرها عند كل حديث في المجالس والدردشات ومواقع التواصل.
وسنتبع هذه الورقة بأختها ليزداد هذا الأمر وضوحًا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) وهو عين المقصود بالمثل العربي السائد: “رمتني بدائها وانسَلَّت” ينظر: الأمثال لابن سلام (ص: 73)، جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (1/ 475)، مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني (1/ 102).
([2]) الاستشراق: دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون كافرون من أهل الكتاب بوجه خاص للإسلام والمسلمين من شتى الجوانب عقيدة وشريعة وثقافة وحضارة وتاريخاً ونظماً وثروات وإمكانيات؛ بهدف تشويه الإسلام، ومحاولة تشكيك المسلمين فيه وتضليلهم عنه، وفرض التبعية للغرب عليهم، ينظر: رؤية إسلامية للاستشراق، أحمد عبد الحميد غراب (ص:7).
([3]) من المؤلفات في ذلك: الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين، شوقي أبو خليل، ومنهج الإسقاط في الدراسات القرآنية عند المستشرقين، د. محمد عامر عبد الحميد مظاهري. وينظر: المنهج عند المستشرقين، عبد العظيم الديب، حوليات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد (7) عام 1409هـ (ص: 363)، ودراسات إسلامية، حسن حنفي (ص: 108 وما بعدها)، وقد أفدت منها في هذه الورقة.
([4]) ينظر: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، محمود حمدي زقزوق (ص: 21).
([5]) ينظر: الاستشراق بين الحقيقة والتضليل، د. إسماعيل علي محمد (ص: 34).
([6]) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (1/ 85 وما بعدها) بتصرف.
([7]) ينظر: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، محمود حمدي زقزوق (ص: 29).
([8]) ينظر: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام، د. علي عبد الحليم محمود (ص: 183).
([9]) أصول علم النفس، د. أحمد عزت راجح (ص: 36 وما بعدها).
([10]) أصول علم النفس، د. أحمد عزت راجح (ص: 478).
([11]) أصول علم النفس، د. أحمد عزت راجح (ص: 36).
([12]) موسوعة علم النفس، أسعد رزق (ص: 40).
([13]) ينظر: منهج الإسقاط في الدراسات القرآنية عند المستشرقين، د. محمد عامر عبد الحميد مظاهري (ص: 5).
([14]) المنهج عند المستشرقين، حوليات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد السابع، عام 1409هـ (ص: 363 وما بعدها).
([15]) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين (ص: 17 وما بعدها).
([16]) الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي (ص: 76).
([17]) العقيدة والشريعة في الإسلام (ص: 49 وما بعدها).
([18]) أصول الفقه ليوسف شاخت، نقلا عن: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، محمد مصطفى الأعظمي (2/ 422).
([19]) ينظر: دراسات في الحديث النبوي، محمد مصطفى الأعظمي (2/ 441 وما بعدها).
([22]) ينظر: سفر أخبار الأيام الثاني (12/ 1).
([23]) ينظر: سفر الملوك الثاني (22/ 8-13)، سفر الملوك الثاني (23/ 102).
([24]) أخبار الأيام الثاني (36/ 17-20).
([25]) ينظر: سفر عزرا (7/ 10).
([26]) ينظر: سفر نحميا (8/ 1-3).
([27]) ينظر: مقارنة الأديان – اليهودية، د. أحمد شلبي (ص: 248).
([28]) قصة الحضارة (2/ 385 وما بعدها).
([29]) قصة الحضارة (2/ 367 وما بعدها).
([30]) مقارنة الأديان – اليهودية (ص: 255 وما بعدها).
([31]) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (13/ 200 -بترقيم الشاملة آليا-).
المصدر : مركز سلف للبحوث والدراسات الإسلامية
 نصرة السنة موقع آخر في مكتب السنة
نصرة السنة موقع آخر في مكتب السنة