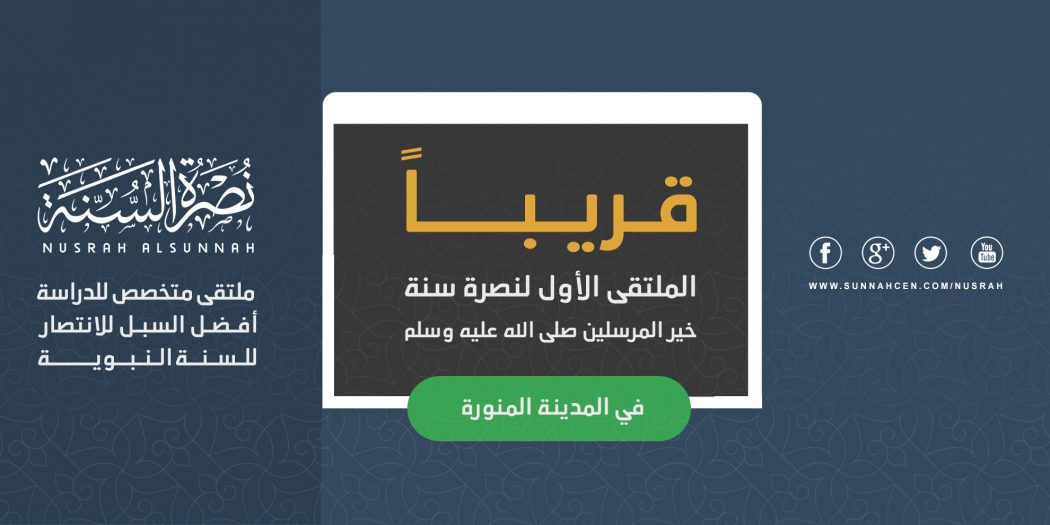الله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، فقد خلق الكون كله، واختار من ذلك ما شاء من الأمكنة والأزمنة ففضل بعضها على بعض. والمفاضلة مفاعلة من الفضل، وهي المقارنة بين شيئين أو جهتين وتغليب أحدهما على الآخر في الفضل، إذا فالمفاضلة إثبات الفضل لشيءٍ على آخر، وتقديمه بذلك عليه، ولذا يقال: فاضلته ففضلته، إذا غلبته في الفضل([1])، “والفِضَال والتفاضُل: التَّمازِي في الفضل، وفضَّله: مزَّاه، والتفاضل بين القوم: أن يكون بعضهم أفضل من بعض، ورجل فاضل: ذو فضل”([2]).
وهذه الورقة معنية بجانب من جوانب المفاضلة وهو التفاضل بين أنبياء الله تعالى عليهم صلوات ربي وسلامه، وقد تناولت هذه المسألة تناولاً يُبرز معالمها وتحقيقاً يحرر مُشكلها سائلاً الله العون والتوفيق وحسن التحرير والتحقيق.
هذا وقد كُتِبَ في هذه المسألة مباحث عديدة في عدة كتب معاصرة منها: التفاضل في العقيدة للدكتور محمد بن عبد الرحمن الشظيفي، وكتاب مسائل النبوة من كتاب أحاديث الأنبياء من الجامع الصحيح للإمام البخاري دراسة عقدية لصفية بنت سيافي أحمد الأمير، وكتاب منهج سُورَة سبأ في تَقْرِيرِ العقيدة لهمَّام حمدان أبو روك، وهذه الكتب قد لا يكون في سعة من هو دون طلاب العلم الاطلاع عليها والاستفادة منها وذلك لطول النفس في تناول المسألة بها وكثرت تفريع الفروع عليها مما يجعل الحاجة ماسة لإيجازها، فأردت بهذه الورقة تقريب المسألة وتوضيحها وتقديمها في قالب مُوجز مفيد، وهذا أوان الشروع في بيانها.
أولا: تقرير التفاضل بين الأنبياء
جاءت الأدلة بالمفاضلة بين الأنبياء، وعلى ذلك نصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة، دلَّت على أنَّ هناك تفاوتًا بين الأنبياء، فليسوا جميعًا في درجة واحدة، وإن استووا في أصل الاختيار والوحي والتبليغ وأنهم جميعا أفضلُ البشر، ومما يدل على ذلك من القرآن:
قوله عز وجل: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ} [البقرة: 253].
قال الشيخ ابن سعدي عند الآية الأولى: “يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة، بحسب ما منَّ الله به عليهم، وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم، فمنهم من اتَّخذه خليلا، ومنهم من كلَّمه تكليمًا، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجاتٍ، وجميعُهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ، وخصّ الله عيسى ابن مريم أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقًّا وعبده صدقًا”([3]).
وقوله سبحانه: {وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} [الإسراء: 55].
قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: {وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}: “من جميع الخلائق، فيعطي كلا منهم ما يستحقّ وتقتضيه حكمته، ويفضّل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية كما فضّل بعض النبيين المشتركين بوحيه على بعض بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما منّ به عليهم من الأوصاف الممدوحة والأخلاق المرضية والأعمال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم، المشتملة على الأحكام الشرعية والعقائد المرضية، كما أنزل على داود زبورا وهو الكتاب المعروف”([4]).
ومما يدل من السنة على أن بين الأنبياء تفاوتًا، فليسوا جميعا في درجة واحدة، وإن استووا في أصل الاختيار والوحي: ما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فُضِّلتُ على الأنبياء بستٍّ: أُعطيتُ جوامعَ الكل، ونُصِرت بالرعب، وأحِلَّت لي الغنائم، وجُعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأُرسِلتُ إلى الخلق كافّة، وخُتِم بي النبيون»([5]). فقوله صلى الله عليه وسلم: «فُضِّلت على الأنبياء» نصٌّ في وقوع التفاضل بين الأنبياء.
وفي حديث المعراج دليل على تفاضل الأنبياء، فإنه عليه الصلاة والسلام مر بأنبياء اختلفت الروايات في تعيين منازلهم في السموات، فمرَّ على آدم وعيسى ويحيى وإدريس ويوسف وهارون وإبراهيم وموسى في كلّ سماء، وتفاوتهم في منازلهم من السموات الوارد في حديث المعراج هو من التفاضل بينهم، فجاء في رواية عند البخاري: «ومُوسَى في السَّابِعَةِ بتَفْضِيلِ كَلَامِ اللَّهِ، فَقالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أظُنَّ أنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أحَدٌ، ثُمَّ عَلَا به فَوْقَ ذلكَ بما لا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ، حتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى، ودَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ العِزَّةِ، فَتَدَلَّى حتَّى كانَ منه قَابَ قَوْسَيْنِ أوْ أدْنَى»([6]).
وأَجْمَعْتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْأَنْبِيَاءِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، وَعَلَى أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنَ الْكُلِّ([7]).
ولا خارق لهذا الإجماع إلا ما نقله البغدادي حيث قال: “وزعم ضرار([8]) أنه لم يكن بعض الأنبياء أفضل من بعض”([9])، لكن قال في موضع آخر: “كان ضرار بن عمرو يقول: لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض بعينه”([10])، وليس هذا نفيًا للتفاضل بل لتعيين الفاضل، ونسب القسطلاني نفي تفاضل الأنبياء إلى مذهب المعتزلة([11])، وقولهم هذا لا يعتدّ به ولا يُلتفت إليه؛ لأنّه مخالف لدلائل الكتاب والسنة، ومخالف لإجماع المسلمين([12]).
ثانيا: وجوه التفاضل بين الأنبياء
أسباب التفضيل بين الأنبياء لا يعلمهما إلا الذي فاضل بينهم سبحانه وتعالى، إلا أنه نبَّهنا سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله إلى شيء من وجوه التفاضل بينهم، فمن ذلك:
– التفضيل بالتخصيص بمنقبة، كتكليم الله موسى، فمن خُصَّ بمنقبة عظيمة من الأنبياء أفضل ممن لم يخصّ.
– والتفضيل بالبيّنات والآيات كما قال سبحانه: {وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ} [البقرة: 87]، وقال صلى الله عليه وسلم: «أعطيتُ جوامع الكلم، ونُصرت بالرعب»([13])، فمن كان من الأنبياء أعظمَ آيات وأكثر معجزات كان أفضل.
– والتفضيل بالتأييد بالملائكة، كما قال سبحانه في عيسى: {وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ} [البقرة: 87]، وروح القدس هو جبريل عليه السلام في أظهر الأقوال([14])، فمن كان تأييد الله له من الأنبياء بالملائكة أكثر وأظهر كان أفضل، قال ابن سعدى في الآية: “وأيده بروح القدس أي: بروح الإيمان، فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد بهذه الروح عامًّا لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: {وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [المجادلة: 22]، لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه بالذكر”([15]). وعليه فكلّ من كان تأييد الله له من الأنبياء بالإيمان أعظم وأقوى كان أفضل.
– والتفضيل بالشرائع كما قال صلى الله عليه وسلم: «وأحلَّت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»([16])، وكما قال سبحانه عن محمد صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157]، وكما حكى الله قول عيسى لليهود: {وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ} [آل عمران: 50]، فكل من أوتي شريعة جديدة من الأنبياء فهو أفضل، ثم كل من كانت شريعته أتم وأيسر فهو أفضل.
– والتفضيل بإنزال كتاب، كما قال سبحانه: {وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} [النساء: 163]، فمن أنزل عليه كتاب أفضل ممن لم ينزل عليه كتاب، ثم التفضيل بما في الكتاب من الشرائع ونحوها بين من أنزل إليهم كتاب.
– والتفضيل بالدرجات كما قال سبحانه: {وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} [البقرة: 253] يعني مراتب متباعدة ووجوه متعدّدة([17]).
– التفضيل بالمراتب في السماء كما في حديث المعراج.
– التفضيل بكثرة الأتباع كما في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، يقول: «عُرِضَتْ عليَّ الأُممُ، فرأيتُ النبيَّ ومَعهُ الرَّهْطُ، والنبيَّ ومعهُ الرجُلَ والرَّجُلانِ، والنبيَّ وليسَ مَعهُ أحَدٌ، إذْ رُفِعَ لِي سَوادٌ عظيمٌ، فظنَنْتُ أنَّهمْ أُمَّتِي، فقِيلَ لِي: هذا مُوسى وقومُهُ، ولكِنِ انْظُرِ إلى الأُفُقِ، فإذا سَوادٌ عظيمٌ، فقِيلَ لِي: انْظرْ إلى الأُفقِ الآخَرِ، فإذا سوادٌ عظيمٌ، فقِيلَ لِي: هذه أُمَّتُكَ»([18]).
ثالثًا: توجيه ما جاء من النهي عن التفضيل بين الأنبياء
وكما قرر الشرع التفاضل بين الأنبياء قرَّر كذلك قضيَّةً هامة وهي: النهي عن المفاضلة بين الأنبياء في بعض الأحوال، فتوهَّم البعض تعارضًا بين هذا وما سبقه، وهنا بيان وتوجيه لذلك:
1- توجيه ما ظاهره التعارض بين الأدلة المقرِّرة للتفضيل بين الأنبياء وبين قوله سبحانه {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: 285]:
وينفك هذا الإشكال بالجمع بين ما ورد من التفضيل بين الأنبياء وبين قوله تعالى: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: 285]، فنقول: إن المراد هنا بالآية ألا يؤمن الإنسان ببعض الرسل ويكفر ببعض كما فعل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، حيث آمنوا برسالة بعض الأنبياء وكفروا برسالة الآخرين، ففرَّقوا بذلك بين رسل الله تعالى، وليس المقصود بالنهي عن التفريق بين الأنبياء النهيَ عن التفضيل بينهم، وبهذا يتبين ألا تعارض بينهما.
وبهذا المعنى قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: {كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ}: “فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره، ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرّقون بين أحدٍ منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارّون راشدون مهديّون هادون إلى سبيل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله، حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي تقوم الساعة على شريعته”([19]).
وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: “أخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه سلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة، وبجميع الرسل، وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنع من آمن ببعض وكفر ببعض، كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة([20]).
2- توجيه ما ظاهره التعارض بين الأدلة المبيّنة للتفضيل بين الأنبياء وبين أحاديث أخرى في السنة:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته، أعطِي بها شيئا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار، فقام فلطم وجهه، وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟! فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟! فقال: «لم لَطمتَ وجهه» فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رئي في وجهه، ثم قال: «لا تفضِّلوا بين أنبياء الله؛ فإنه ينفخ في الصور، فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بُعِث، فإذا موسى آخذٌ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي؟»([21]).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُخَيِّرُوا بيْنَ الأنْبِياءِ» الحديث([22])، وفي روايةٍ: «لا تُخَيِّرُونِي مِن بَيْنِ الأنْبِياءِ»([23])، وفي رواية: «لا تُفَضِّلُوا بيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ»([24])، وقال: «لا تُخَيِّرُونِي علَى مُوسَى»([25]).
وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى»([26]).
الجمع بين تلك النصوص:
قال ابن كثير رحمه الله: “فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية -أي: قوله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}- وبين قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تُخَيِّرُوا بيْنَ الأنْبِياءِ» الحديث وفي رواية: «لا تُفَضِّلُوا بيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ»، فالجواب من وجوه:
أحدها: أن هذا كان قبل أن يَعلَم بالتفضيل، وفي هذا نظر.
الثاني: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع.
الثالث: أن هذا نهيٌ عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر.
الرابع: لا تفضّلوا بمجرد الآراء والعصبية.
الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به”([27]).
وقال رحمه الله عند قوله تعالى: {وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} [الإسراء: 55]: “وكما قال تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ}، وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تُفَضِّلُوا بيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ»، فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرَّد التشهِّي والعصبية، لا بمقتضى الدليل، فإذا دلَّ الدليل على شيء وجب اتباعه، ولا خلاف أن الرسل أفضلُ من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصًّا في آيتين من القرآن: في سورة الأحزاب: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [الأحزاب: 7]، وفي الشورى في قوله: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13]، ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام على المشهور”([28]).
وقال رحمه الله عند حديثه عن فضل يونس: “قال الله تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 139]، وذكره تعالى في جملة الأنبياء الكرام في سورتي النساء والأنعام -عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام-“([29])، ثم ذكر بعد ذلك الروايات التي وردت عند البخاري ومسلم وأحمد والطبراني والتي جاءت في شأن يونس بن متى عليه السلام، ثم قال: “أي: ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس، والقول الآخر: لا ينبغي لأحد أن يفضِّلني على يونس بن متى كما قد ورد في بعض الأحاديث: «لا تفضِّلوني على الأنبياء»، وهذا من باب الهضم والتواضع منه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين”([30]).
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عند قول الطحاوي: (وسيد المرسلين): “إن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهوديّ: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه المسلم وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟! فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؛ لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذمومًا، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حميَّة وعصبية كان مذمومًا، فإن الله حرم الفخر وقد قال تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ} [البقرة: 253]، فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر، أو على وجه الانتقاص بالمفضول، وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تُفَضِّلُوا بيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ»، وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تُخَيِّرُونِي علَى مُوسَى» وقوله: «لا تُفَضِّلُوا بيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ» نهي عن التفضيل الخاصّ أي: لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله: «أنا سيِّدُ ولدِ آدمَ ولا فَخرَ»([31])، فإنه تفضيل عامّ فلا يمنع منه”([32]).
ثم قال رحمه الله فيما ورد من النهي عن التفضيل على يونس: “وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تفضلوني على يونس» فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح: «لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى»، وفي رواية: «مَن قالَ: أنا خَيْرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى فقَدْ كَذَبَ»([33])، وهذا اللفظ يدلّ على العموم، أي: لا ينبغي لأحد أن يفضّل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضّلوا محمدًا على يونس؛ وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التَقَمَه الحوت وهو مليم، أي: فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى: {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء: 87]، فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس، فلا يحتاج إلى هذا المقام؛ إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظنّ هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: {أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء: 87]”([34]).
وقال النووي رحمه الله: “وأما الحديث الآخر: «لا تُفَضِّلُوا بيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ» فجوابه من خمسة أوجه:
أحدها: أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيّد ولد آدم، فلما علم أخبر به.
والثاني: قاله أدبا وتواضعا.
والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدّي إلى تنقيص المفضول.
والرابع: إنما نهى عن تفضيل يؤدِّي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث.
والخامس: أنّ النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى”([35]).
قال الشيخ حافظ الحكمي بعدما نقل كلام النووي رحمه الله: “ذكر ابن كثير رحمه الله وجهًا آخر، وهو: أن التفضيل ليس إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمان به”، ثم قال: “الوجه الأول من كلام النووي ضعيف، والثاني والخامس فيهما نظر، والرابع قريب. ويقوى عندي الوجه الثالث مع ما ذكره ابن كثير، فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية، ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحطّ من قدره، كل هذا وما في معناه محرم قطعا منهيّ عنه شرعًا، وهو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقصده ذلك الأنصاري رضي الله عنه، فغضبُ النبي صلى الله عليه وسلم ونهيُه عن ذلك تعليم عامّ للأمة وزجر بليغ لجميعهم؛ كيلا يقع ذلك أو يصدر عن أحد منهم فيهلك. وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجته ونوّه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا ومما لم نذكر فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق والانقياد له والتسليم، فلا يؤخذ علم ما يختص بالله ورسوله إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم”([36]).
وقال النووي أيضا في توجيه الحديث الآخر الذي فيه النهي عن التفضيل على يونس بن متى: “قال العلماء: هذه الأحاديث تحتمل وجهين:
أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس، فلما علم ذلك قال: «أنا سيِّدُ ولدِ آدمَ»، ولم يقل هنا: إن يونس أفضل منه أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرا عن أن يتخيّل أحد من الجاهلين شيئا من حطّ مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن العزيز من قصته، قال العلماء: وما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحطَّه من النبوة مثقال ذرةٍ، وخص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس» فالضمير في (أنا) قيل: يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: يعود إلى القائل أي: لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو علم أو غير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ من الفضاء ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة”([37]).
وقال ابن حجر: “في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه، لا من يقوله بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدّي إلى تنقيص المفضول، أو يؤدّي إلى الخصومة والتنازع، أو المراد: لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة، فالإمام مثلا إذا قلنا: إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان، وقيل: النهي عن التفضيل إنما هو في حقّ النبوة نفسها كقوله تعالى: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: 285]، ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [البقرة: 253]، وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة؛ لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر، فيفضي إلى الكفر، فأما إذا كان التخيير مستندًا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي”([38]).
أما عن الأحاديث التي وردت بشأن يونس عليه السلام فيقول ابن حجر رحمه الله بعد إيراده لرواية: «لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى»، وأبي هريرة: «لَا أَقُولُ: إنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى عليه السَّلَامُ»([39]) يقول: “وقد وقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني الواردة بلفظ: «لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى»([40]). وهذا يؤيد أن قوله في الطريق الأول: (إني) المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: «لا ينبغِي لأحدٍ أن يقولَ: أنا عندَ اللهِ خيرٌ من يونسَ بنِ متَّى»([41])، وفي رواية للطحاوي: أنه سبح لله في الظلمات، فأشار إلى الخيرية المذكورة”([42]).
غير أنه قال في موضع آخر عند قوله صلى الله عليه وسلم: «وما ينبغي لأحدٍ أنْ يقولَ: أنا خيرٌ من يونُسَ بنِ مَتَّى»: “يحتمل أن يكون المراد أن العبد القائل هو الذي لا ينبغي له أن يقول ذلك، ويحتمل المراد بقوله: «أنا» رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله تواضعا، ودل حديث أبي هريرة: «مَن قالَ: أنا خَيْرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى فقَدْ كَذَبَ» على أن الاحتمال الأول أولى”([43]).
وللشوكاني رحمه الله في هذه القضية اجتهاد خاصّ به، حيث قال بعد نقله لأقوال بعض الأئمة في الجمع بين النصوص السابقة: “وفي جميع هذه الأقوال ضعف، وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة، فإن القرآن دل على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض، وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض، فإن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله لا تخفى عليه منها خافية، وليست بمعلومة عند البشر، فقد يجهل أتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته فضلا عن مزايا غيره، والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلا وهذا مفضولا، لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلها، فإن ذلك تفضيل بالجهل، وإقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له وهو ممنوع منه، فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن في الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياء، فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالنهي عن ذلك؟! وإذا عرفت هذا علمت أنه لا تعارض بين القرآن والسنة بوجه من الوجوه، فالقرآن فيه الإخبار من الله بأنه فضل بعض أنبيائه على بعض، والسنة فيها النهي لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه، فمن تعرض للجمع بينهما زاعما أنهما متعارضان فقد غلط غلطا بينا”([44]).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([3]) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: 91).
([5]) أخرجه البخاري (3535)، ومسلم (2286).
([7]) ينظر: تفسير الرازي (6/ 521).
([8]) هو ضرار بن عمرو الغطفاني، معتزليّ جلد، له مقالات خبيثة. انظر: ميزان الاعتدال (2/ 328)، ولسان الميزان (3/ 203).
([11]) المواهب اللدنية (2/ 42).
([12]) ينظر: مباحث المفاضلة في العقيدة (ص: 119).
([13]) أخرجه البخاري (3535)، ومسلم (2286).
([14]) انظر: تفسير الطبري (1/ 320)، وتفسير القرطبي (2/ 24)، وتفسير ابن كثير (1/ 123)، وروح المعاني (1/ 317)، وأضواء البيان (1/ 69) وغيرها.
([15]) تيسير الكريم الرحمن (1/ 150).
([16]) أخرجه البخاري (3535)، ومسلم (2286).
([17]) ينظر: روح المعاني (3/ 2).
([18]) أخرجه البخاري (6541)، ومسلم (220).
([19]) تفسير القرآن العظيم (1/ 342).
([20]) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: 100).
([22]) أخرجه البخاري (2412)، ومسلم (2374).
([23]) صحيح البخاري (6917)، وصحيح مسلم (2374).
([24]) صحيح البخاري (3414، 3415)، وصحيح مسلم (2373).
([25]) صحيح البخاري (6517)، وصحيح مسلم (2373).
([26]) أخرجه البخاري (3395)، ومسلم (2377).
([27]) تفسير القرآن العظيم (1/ 304).
([28]) تفسير القرآن العظيم (3/ 46).
([29]) البداية والنهاية (1/ 221).
([30]) البداية والنهاية (1/ 221-222).
([32]) شرح العقيدة الطحاوية (1/ 158-160) بتصرف.
([33]) أخرجه البخاري (3414، 3415)، ومسلم (2373).
([34]) شرح العقيدة الطحاوية (1/ 161-163) بتصرف.
([35]) شرح صحيح مسلم (15/ 37-38).
([36]) معارج القبول (2/ 520-521) بتصرف.
([37]) شرح صحيح مسلم (15/ 132-133).
([39]) البخاري (3414، 3415)، ومسلم (2373).
([41]) ينظر: البداية والنهاية (1/ 221)، ومجمع الزوائد (8/ 212).
([42]) ينظر: فتح الباري (6/ 520-521).
([43]) فتح الباري (6/ 116-117).
([44]) انظر: منهج الإمام الشوكاني في العقيدة (ص: 657).
المصدر : مركز سلف للبحوث والدراسات الإسلامية
 نصرة السنة موقع آخر في مكتب السنة
نصرة السنة موقع آخر في مكتب السنة