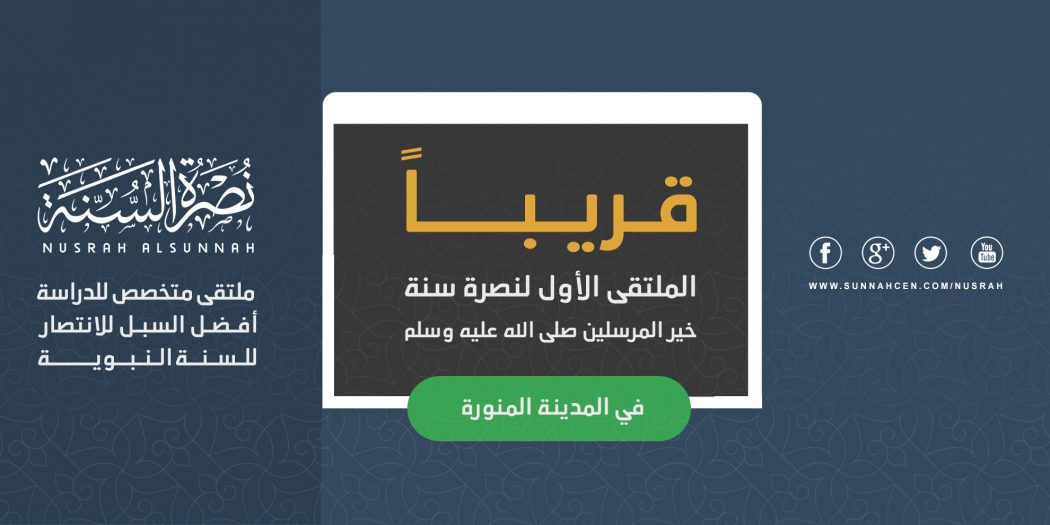المقدمة:
تمر الأمة الإسلامية اليوم بعاصفة جارفة وطوفان هائل من الشبهات والتشكيكات حول الدين الإسلامي، فلقد تداعت عليها الأمم -كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم- من كل جانب من أديان باطلة ومذاهب منحرفة وفرق مبتدِعة، كلها تصوّب السهام نحو الدين الإسلامي، ولا يكاد يسلَم من هذا الطوفان أصل من أصول الدين الإسلامي ولا معتقد من معتقدات أهل السنة والجماعة.
“فالشبهات المعاصرة أشبهُ بالطوفان الكاسح الذي لا يفرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة والمتعلّم والعامي، ويصل إلى الناس في عقر بيوتهم وفي حجرات نومِهم، وتكفي ضغطة زر يسيرة لأن تقذف بالشاب أو الفتاة في بحر متلاطم من الأفكار والمذاهب والشبهات”([1]).
وأمام هذا الطوفان الهائل افترق الناس في التعامل مع هذه الشبهات، وطفا في الساحة تساؤل مهمّ، وهو: كيف كان منهج السلف وأئمة الدين في التعامل مع الشبهات؟ وكيف واجهوها؟
وفي هذه الورقة العلمية نجيب عن هذا السؤال، ونبحث عن حال السلف وأئمة الهدى من بعدهم مع الشبهات على اختلاف عصورهم، بتوفيق الله وحسن عونه.
تمهيد:
ليست الموجة الحالية هي الأولى في تاريخ إثارة الشبهات حول الدين الإسلامي، بل سبقتها موجات كثيرة من التشكيك والتلبيس، فلقد مر الدين الإسلامي قبله بتجارب وإن اختلفت في القوة ومدى التأثير ووسائل البثّ ومدى الانتشار ونوعية المستهدفين بالشبهات، إلا أن الدين الإسلامي خرج من تلك الدسائس مصقولا صافيًا كالذهب الإبريز، كلما اشتدت عليه سموم النيران صفا أكثر، ومع تصاعد الصدع بالشبهات والتشكيكات يصعد الدين الإسلامي إلى أعلى المراتب، وينتصر على كل المذاهب بمن يسخِّره الله لنصرته من معتنقيه، بل ومن أعدائه أو من أصلاب أعدائه.
نعم، هذا هو الحال دومًا وفي كل زمان، والقصة تتكرر في كل وقت، وإن تغيرت أسماء شخصياتها واختلفت وسائلهم، فالتاريخ يعيد نفسه كما يقال.
يقول ابن العربي المالكي: “خذوا مني في ذلك نصيحة مشحونة بنكت من الأدلة، وهي أن الله سبحانه رد على الكفار على اختلاف أصنافهم، من ملحدة وعبدة أوثان وأهل كتاب وطبيعة وصابئة [وشركية] ويهودية بكلامه، وساق أفضل سياق أدلته، وجاء بها في أحكم نظام، وأبدع ترتيب، فعلى ذلك فعوّلوا… فهو قد أنزل كتابه على نبيه نورا محكَما، هدًى تِبيانا، لم يكن رموزا ولا كناية عما لا يتوصّل به إليه سامعه ولا يعلمه مخاطبه، وأقام عشرة أعوام -أو ثلاثة عشر عاما، أو خمسة عشر عاما- يجادل بالحجة جميع الكفرة، بألف من آي القرآن… فما بقي نوع من الأدلة، ولا وجه من وجوه الحجج، إلا وجاء بها على أوضح منهج، وتناولت كل حجة طائفة من الملحدة وأصحاب الطبائع والصابئة بقدرها، واليهود والنصارى والزائغين بقسطها، على نحو ما قالت كل طائفة من الشرك، ولو شاء ربنا لكفّهم عن هذه المقالات، وإذ أطلقها على ألسنتهم فقد نصّ كيف تنقَض أقوالهم، حسبما تقرر من الأدلة، ومن كيفية استعمال في كتابه، وعلى لسان رسوله، وذلك كله بسابقة من المشيئة ووجوه من الحكمة”([2]).
فالله سبحانه وتعالى هو الذي وعد بحفظ القرآن ودين الإسلام، فهو القائل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، أي: “وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه”([3])، وقد صدقنا وعده وهو لا يخلف الميعاد، بل هناك ما هو أكثر من ذلك.
وهو أن هذه علامات بشارات وانتصارات قادمة لدين الإسلام، فإن “من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين… وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له مما يحقّ به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من أدلة الحقّ وبراهينه الواضحة، وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة”([4]).
تأصيل الحقّ ومعرفته بدليله مطلبٌ مقدم على كل مطلب:
عندما يبدَأ مهندس معماريّ بتنفيذ مشروع ما من المشاريع فإنَّ من أهمّ ما يفكّر ويخطّط له الأساسَ والقاعدة التي يقيم عليها ذلك المشروع، فلا بدّ لذلك الأساس أن يكون رصينًا متينا لا يتصدَّع ولا يتأثر بعوامل الطبيعة من أمطار ورياح وغيرها؛ ذلك أن الأساس هو أصل كل مشروع.
وفي ديننا الإسلامي لا بد من التأصيل وبناء الأساس، فلا بد من معرفة الدين الحق وأدلته قبل الخوض في ردّ الشبهات، فعلى المسلم أولا تأصيلُ نفسه في الدين عقيدة وشريعة، والإلمام بأصول المسائل وأدلتها قبل الخوض في غمار الشبهات والإشكالات؛ ذلك أن المسلم محتاج إلى معرفة ما قاله الله تعالى ورسوله في مسائل الدين، ووعيها واستيعابها على وجهها، ثم الإيمان بها واليقين بها، فحاجة المسلمين إلى هذا تسبق حاجتهم إلى ردّ الشبهات وتفنيد الإشكالات والردّ على المخالفين، فمن تأصّل في العلوم الشرعية وعرف أصول الاعتقاد وأحكم مسائل الدين اشتغل بعد ذلك بالدفاع عن ذلك الحقّ الذي علمه وآمن به واعتقده وعمل به، أما أن يبدأ بمجادلة المشكِّكين ومناظرتهم في أقوالهم قبل أن يؤصّل المسائل ويحقق الإيمان في نفسه، فهو كحال من يحافظ على الصدف ولا يدري أفي داخله جوهر أم حجر! وكمن ينشغل بحراسة الفناء عن بناء البيت.
ومن هنا يتضح لنا أن غرس العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين والنشء على وجه الخصوص له الأولوية من بين كل الأمور، وغرس الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر لا بد أن يُعطَى حظَّه قبل الخوض في ميدان ردّ الشبهات وتفنيدها، ومن أراد الخوض فيها فلا بد أن يكون قد أصّل نفسه وتمكّن من العلوم الشرعية حتى يستطيع الخوض فيها دون زلل أو خلل.
يقوا ابن تيمية رحمه الله: “لا بد أن يكون المحروس هو نفس ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر به لأمته، فأما إذا كان المحروس فيه ما يوافق خبر الرسول وفيه ما يخالفه، كان تمييزه قبل حراسته أولى من الذب عما يناقض خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن حاجة المؤمنين إلى معرفة ما قاله الرسول وأخبرهم به -ليصدقوا به، ويكذبوا بنقيضه، ويعتقدوا موجبه- قبل حاجتهم إلى الذب عن ذلك، والرد على من يخالفه، فإذا كان المتكلم الذي يقول: إنه يذب عن السنة قد كذَّب هو بكثير مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقد نقيضه كان مبتدعًا مبطلًا متكلمًا بالباطل فيما خالف فيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن ما وافق فيه خبر الرسول فهو فيه متبع للسنة، محقّ يتكلم بالحق”([5]).
وهذا المنهج نجده في القرآن الكريم الذي يسعى إلى ترسيخ ثوابت الدين الحنيف وأسسه من توحيد وصلاة وزكاة وصوم وحج وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، غير مبالٍ بتشكيكات المشككين وشبهات المغرضين، فالآيات المكية يغلب عليها طابع الدعوة إلى ترسيخ العقائد والأصول لتستقر في النفوس([6])، ومع ذلك كانت الإشكالات الجوهرية قد تناولها القرآن بالرد والتفنيد؛ كدعوى كون النبي صلى الله عليه وسلم ساحرًا أو شاعرًا أو مجنونًا: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الحاقة: 38-43].
وأما إشكالات المشغّبين وتعريضات المعرضين فإن القرآن الكريم كثيرا ما يأمر بالإعراض عنها كما قال تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} [الحجر: 94]، وقال: {اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 106]، وغيرها من الآيات.
وهذا ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: «الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما مشبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتَّقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه، ألا وهي القلب»([7]).
وهذا ما نجده جليًّا واضحًا في نصوص السلف رحمهم الله عند ظهور الشبهات والبدع، ومن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: (عليكم بالعلم قبل أن يقبَض، وقبضه أن يذهب أهله، وإنكم ستجدون قوما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله، وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق)([8]).
وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة: “عليك بلزوم السنة؛ فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت عصمة ليستن بها ويقتصر عليها، فإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعميق، فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفّوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبفضل لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن حدَثَ حدثٌ بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم”([9]).
أهمية الإعراض عن الشبهات والبعد عنها خشية الافتتان بها:
والقرآن الكريم نص صراحة على هذا الأمر فقال: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68] قال الإمام الطبري رحمه الله: “{وَإِذَا رَأَيْتَ} -يا محمد- المشركين {الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا} التي أنزلناها إليك، ووحينا الذي أوحيناه إليك، وخوضهم فيها كان استهزاءَهم بها، وسبَّهم من أنزلها وتكلم بها، وتكذيبهم بها، {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ}، يقول: فصد عنهم بوجهك، وقم عنهم، ولا تجلس معهم”([10]).
وأقوال السلف وسيرهم معروفة في هذا الباب، فالخليفة الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله صَبيغ عن {الذَّارِيَاتِ ذَرْوًا} وأشباهه سيَّره إلى الشام، وزجر الناس عن مجالسته، مع أنه كان سائلًا عن شيء من القرآن، ولكن بغرض تتبّع الشبهات([11]).
قال الآجري: “لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب عن هذه المسألة، ولكن لما تأدّى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون، قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلّب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به، فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه، سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه، حتى ينكّل به، وحتى يحذّر غيره”([12]).
وقيل لابن عمر رضي الله عنه: إن نجدة الحروري -وهو على رأس أهل البدع- يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه؛ كراهية أن يقع في قلبه منه شيء([13]).
وكذلك كان موقف التابعي الجليل محمد بن سيرين حين أتاه رجلٌ من أهل الكلام، فقال: ائذن لي أن أحدّثَك بحديث، قال: لا أفعل، قال: فأتلو عليك آية من كتاب الله؟ قال: ولا هذا، فقيل له في ذلك، فقال ابن سيرين: لم آمَنْ أن يذكرَ لي ذكرًا يقدح به قلبي([14]).
وورد عنه أيضا أن رجلا دخل عليه في بيته، فذكر له شيئا من القدر، فقال محمد: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90] قال: وأخذ بأصبعيه في أذنيه فقال: لتخرجن من عندي أو لأخرجن عنك، فخرج الرجل فقالوا: يا أبا بكر، لو سمعت من الرجل، فقال محمد: إن قلبي ليس بيدي، وإني خفت أن ينفث في قلبي شيئًا لا أستطيع أن أخرجه من قلبي، فكان أحب إلي أن لا أسمع كلامه”([15]).
وقال أبو قلابة: “لا تجالسوا أصحاب الأهواء -أو قال: أصحاب الخصومات-، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون”([16]).
ومما يبين لنا نصاعة هذا الموقف الذي وقفه السلف وأصالته أن الإيمان بأصول الإسلام ليس متوقفًا على ردّ كل ما يثار حولها من شبهات؛ إذ السفسطة والشبهات لا حدَّ لها ولا منتهى لها؛ إذ “ما من حقّ ودليلٍ إلا ويمكن أن يرِد عليه شبه سوفسطائية”([17])، ولو توقف الأمر على ذلك لما آمن أحد بشيء، وقد تساءل الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذا فقال: “فلو قال قائل: هذا الذي علمتموه لا يثبت لا بالجواب عما عارضه من العقليات، قالوا لقائل هذه المقالة: هذا كذب وبهت، فإن الأمور الحسية والعقلية واليقينية قد وقع فيها شبهات كثيرة تعارض ما علم بالحس والعقل، فلو توقف علمنا بذلك على الجواب عنها وحلّها لم يثبت لنا ولا لأحد علم بشيء من الأشياء، ولا نهاية لما تقذف به النفوس من الشبه الخيالية، وهي من جنس الوساوس والخطرات والخيالات التي لا تزال تحدث في النفوس شيئا فشيئا، بل إذا جزمنا بثبوت الشيء جزمنا ببطلان ما يناقض ثبوته، ولم يكن ما يقدر من الشبه الخيالية على نقيضه مانعا من جزمنا به، ولو كانت الشبهة ما كانت، فما من موجود يدركه الحس إلا ويمكن كثير من الناس أن يقيم على عدمه شبها كثيرة يعجز السامع عن حلها”، إلى أن قال: “وهذه الشبه كلها من واد واحد، وهي خزنة الوساوس، ولو لم نجزم بما علمناه إلا بعد العلم برد تلك الشبهات لم يثبت لنا علم أبدا، فالعاقل إذا علم أن هذا الخبر صادق علم أن كل ما عارضه فهو كذب، ولم يحتج لأن يعرف أعيان الأخبار المعارضة له ولا وجوهها”([18]).
وقد يقول قائل من الناس: أنا أملك الفضول وأحبّ القراءة والاطلاع على أقوالهم وشبهاتهم وإيراداتهم على الإسلام وأصوله، فلقد أجاب الإمام ابن بطة العكبري على هذا فقال: “لا يحملنّ أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره، أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشدّ فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب، وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبَوا إليهم”([19]).
ويزداد هذا الرأي قوّة إذا عرفنا أن أصحاب الشبهات “ما كانوا يظهرون من قولهم للناس إلا ما هو أبعد عن أن يكون معروفًا مستيقَنًا من الدين عند العامة والخاصة، وأقرب إلى أن يكون فيه شبهة ولهم فيه حجة، ويكونون فيه أقل مخالفة لما يعلمه الناس من الحجج الفطرية والشرعية والقياسية وغير ذلك، فهذا شأن كل من أراد أن يُظهر خلاف ما عليه أمة من الأمم من الحقّ، إنما يأتيهم بالأسهل الأقرب إلى موافقتهم، فإن شياطين الإنس والجن لا يأتون ابتداء ينقضون الأصول العظيمة الظاهرة، فإنهم لا يتمكنون، ومما عليه العلماء أن مبدأ الرفض كان من الزنادقة”([20]).
إن كان الأمر كذلك فهل لمناقشة الشبهات أهمية؟
هذا الإعراض يكون مفيدًا لعامة المسلمين ممن لم يطرق سمعه الشبهات والإشكالات، فأما إذا ذاعت الشبهات وانتشرت وأصبحت في مسمع ومرأى من المسلمين، فلا بد من مناقشتها وتفنيدها، لا لإفحام صاحبها ولا لإقناعه بالدرجة الأولى، ولكن لتثبيت أهل الإسلام ودفع الوساوس عنهم، كما نجد ذلك في القرآن الكريم مع من أثار حوله الشبهات في وقت نزوله، فمما قالوه ما ذكره الله في قوله: {وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ} [ص: 6، 7]، وقوله: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} [المدثر: 25]، وقوله: {لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} [الأنفال: 31]، وقالوا: {إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ} [الفرقان: 4]، {وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الفرقان: 5].
فكان الرد والتفنيد لهذه الشبهات والإشكالات سريعًا محكمًا، قال تعالى: {فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا} [الفرقان: 4]، وقال تعالى: {قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} [الفرقان: 6]، {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: 102]، وقال: {لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ} [النحل: 103]، ثم قال: {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88].
والقرآن الكريم مليء بالردود على الشبهات التي يبثها أعداء الإسلام، سواء من المشركين أو اليهود أو النصارى أو غيرهم من أهل الأديان، بل أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم لا يأتون بشيء من الشبهات إلا جاء الرد بأحكم وأقوى مما لبَّسوا به، فقال: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} [الفرقان: 33]، أي: “ولا يأتيك -يا محمد- هؤلاء المشركون {بِمَثَلٍ} يضربونه {إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ}: بما نبطل به ما جاؤوا به، {وَأَحْسَنَ} مما جاؤوا به من المثل بيانا وتفصيلا”([21]).
وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحبّ إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل([22]).
قال ابن تيمية رحمه الله معلقا: “فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم، من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين”([23]).
وانتشار الشبهات حول الدين هو ما اضطر العلماء قديما وحديثا إلى الرد عليها وتفنيدها وإبطالها، ولم ينتصبوا رأسًا لدراستها إلا حين انتشرت، “فلم يجد العلماء بدّا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارا”([24]).
وقد جلّى لنا هذا المعنى الإمام الدارمي رحمه الله، فبين أن من سلِم من انتشار الشبهات والإشكالات في زمنه فقد أعرض عن مناقشتها، وأما من ابتلي بانتشارها وبثها بين العامة فلا بد له من نصر الإسلام والسنة بكشف الشبهات وتفنيدها، قال رحمه الله: “ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين حتى كان الآن بأخرة؛ حيث قلَّت الفقهاء وقبض العلماء، ودعا إلى البدع دعاة الضلال؛ فشدّ ذلك طمع كل متعوّذ في الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق، ووجدوا فرصة للكلام؛ فجدّوا في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام، وإنكار صفاته وتكذيب رسله وإبطال وحيه؛ إذ وجدوا فرصتهم، وأحسّوا من الرعاع جهلا، ومن العلماء قلة؛ فنصبوا عندها الكفر للناس إماما بدعوتهم إليه، وأظهروا لهم أغلوطات من المسائل وعمايات من الكلام، يغالطون بها أهل الإسلام؛ ليوقعوا في قلوبهم الشك، ويلبسوا عليهم أمرهم، ويشككوهم في خالقهم، مقتدين بأئمتهم الأقدمين الذين قالوا: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ البَشَرِ} [المدثر: 25] و{إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ} [ص: 7].
فحين رأينا ذلك منهم، وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل، ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى؛ رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم؛ فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم؛ محتسبين منافحين عن دين الله تعالى، طالبين به ما عند الله.
وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، وقد كانوا رزقوا العافية منهم، وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء؛ فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق”([25]).
وقد عد الإمام النووي رحمه الله الرد على الشبهات من النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى فقال: “أما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأن كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين”([26]).
وقد بين الإمام ابن قتيبة أن الحال يختلف في زمن انتشار الشبهة عن زمن خمودها واندثارها، وأنكر على من أمر بالسكوت عن الفتنة بعد انتشارها، فقال: “يجوز أن يؤمر بهذا قبل تفاقم الأمر ووقوع الشحناء، وليس في غرائز الناس احتمال الإمساك عن أمر في الدين قد انتشر هذا الانتشار وظهر هذا الظهور، ولو أمسك عقلاؤهم ما أمسك جهلاؤهم، ولو أمسكت الألسنة ما أمسكت القلوب، وقد كان لهؤلاء أسوة فيمن تقدم من العلماء حين تكلم جهم وأبو حنيفة في القرآن، ولم يكن دار بين الناس قبل ذلك ولا عرف، ولا كان مما تكلم الناس فيه، فلما فزع الناس إلى علمائهم لم يقولوا هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها ولم يتكلفوها، ولكنهم أزالوا الشكّ باليقين، وجلوا الحيرة وكشفوا الغمة، وأجمع رأيهم على أنه غير مخلوق، فأفتوهم بذلك، وأدلوا بالحجج والبراهين، وناظروا وقاسوا واستنبطوا الشواهد من كتاب الله عز وجل”([27]).
وبين الإمام ابن عبد البر أن الأصل هو نشر الحقّ وتأصيله وبثّه بين المسلمين، ولكن يختلف هذا الأصل إذا انتشر الباطل وبثّت الشبهات، فالأصل نشر الحقّ، “إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع بردّ الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلال عامة”([28]).
وهذا الموقف الوسط بين قضية تأصيل الحقّ ونشره وبين تتبّع الشبهات؛ فليس بصحيح أن يكون تتبع الشبهات والردّ عليها هو المشروع الأول في الأمة والشغل الشاغل لأهل العلم، وإنما الأصل هو بثّ الحق ونشر أصول الدين وتعليم العقائد الصحيحة، ثم إذا وردت شبهة على شيء من الأصول أو نشر أحدٌ ما شبهة من الشبه بين المسلمين أو احتاج الناس إلى الرد على شبهة بُيِّن ذلك للناس لحاجتهم، “والقرآن لا يذكر فيه مخاطبة كل مبطل بكل طريق، ولا ذكر كل ما يخطر بالبال من الشبهات وجوابها، فإن هذا لا نهاية له ولا ينضبط، وإنما يذكر الحق والأدلة الموصلة إليه لذوي الفطر السليمة، ثم إذا اتفق معاند أو جاهل كان من يخاطبه من المسلمين مخاطبًا له بحسب ما تقتضيه المصلحة، كما يحتاج إلى الترجمة أحيانًا، وكما قد يستدل على أهل الكتاب بما يوجد عندهم من التوراة والإنجيل.
ففي الجملة: الطرق التي تختص بطائفة طائفة مع طولها وثقلها على جمهور الخلق لا تكون في مثل الكتاب العزيز الذي جعله الله شفاءً ورحمةً، ودعا به الخلق جميعهم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، فإن مثل هذا الكتاب العزيز لا يليق أن يذكر فيه من الطرق ما يثقل على جمهور الخلق [ويتركونه] ويعدونه لكنةً وعِيًّا لا يحتاج إليه، ويرونه من باب إيضاح الواضحات، كما لو ذكر فيه الرد على السوفسطائية ببيان أن الشمس موجودة، والقمر موجود، والبحار موجودة، والجبال موجودة، والكواكب موجودة، وأن الإنسان يعلم هذا بالمشاهدة”([29]).
فالرد يكون على الشبهات المنتشرة الرائجة بين الناس، وذلك لمصلحة نصر السنة والدين بتفنيدها والرد عليها، وليس بصحيح أن يختلق المرء شبهًا معدومة أو يتتبع شبهًا مغمورة، فإنه “ما جنِي على المسلمين جناية أعظم من هؤلاء، ولم يكن للمبتدعة قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدًا ودردا، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا، وعلى المداهنة خِلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادًا، وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرِّونهم في وجوههم عيانا، ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين، وهيهات ما بين المقامين”([30]).
فالأصل عدم تكلّف الرد على شبهات لم يقل بها أحد، أو لم تنتشر ولا يخشى ضررها على الناس؛ لأن ذلك مظنةٌ لبثها بدلًا من دحضها، ولنشرها بدلًا من وأدها.
ولكن لا بد لمن أراد أن يخوض باب الشبهات والردّ عليها أن يكون حال قلبه معها كما نصح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه حيث يقول ابن القيم رحمه الله: “وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه -وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد-: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة، فيتشربها، فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات، أو كما قال؛ فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك”([31]).
ففرق في الرد على الشبهات بين عالم متمكّن يستطيع استيعاب الشبهة والرد عليها دون أن تمس إيمانه ويقينه، وبين من هو إسفنجيّ القلب والسريرة، “فالعالم الراسخ هو الذي إذا حصل له العلم الشافي بقضية لزمها ولم يبال بما قد يشكّك فيها، بل إما أن يعرض عن تلك المشككات، وإما أن يتأملها في ضوء ما قد ثبت”([32]).
ولا يصح للمسلم أن يذكر شبهة من الشبهات في مجلس أو منتدى أو غير ذلك دون أن يكشف زيفها ويعري زخرفها ويبين عن مكامن خطئها، وليس له تأخير الرد، ولا التوسع في عرض الشبهة والاقتضاب في ردّها، فقد تردّ على شخص ما وترسّخ الشبهة في نفسه ولا يستطيع الفكاك منها أو التخلّص من جزء من أجزائها المغلوطة، أو تدخل عليه شكًّا يضعف إيمانه ويخدش يقينه، فالشبه خطافة([33]).
لا يتولى الرد على الشبهات وتفنيدها إلا من كان أهلا لذلك:
ليس المقصود بالتفصيل السابق أن كلّ من يرى من نفسه قوة على الرد ولج هذا الباب ورد على أصحاب الشبهات، بل لا بد أن يكون الإنسان مؤهلًا للرد ليدخل إلى هذا الباب، ونستطيع إجمال هذه الشروط فيما يلي:
- شروط علمية عامة تتضمن المعرفة الصحيحة بالإسلام ومصادره وعلومه التي لا بد منها.
- شروط علمية خاصة بالباب أو المسألة محل الرد، سواء مسألة عقدية أو فقهية أو حديثية أو غيرها.
- معرفة مجملة بفنون الرد وطرائق إقامة الحجة ودفع الشبهات وأساليب الحوار.
- معرفة كافية بالمذهب أو النحلة أو القول المردود عليه من حيث طبيعته وقائله والأساس الذي بني عليه ومقاصد أصحابه.
- مجموعة من الصفات والقدرات العقلية والنفسية والمهارية التي لا بد منها في القائم بالرد؛ كالذكاء وسرعة البديهة وحسن التصرف والتخلص من المآزق وإحراج الخصوم وضبط النفس([34]).
وتصدُّر غير المتأهل للردّ فتنة للمسلمين والكافرين، وضرره عظيم على البشرية جمعاء، وقد ذمّه أئمة السلف كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: “فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به، وأقرب من السلامة له إن شاء الله”([35]).
الخاتمة:
فالأصل هو نشر الخير وبث أصول العلم والإيمان، وأما تفنيد الشبهات فيحتاج إليه عند انتشار شبهة ما ورواجها وخوف الفتنة على الناس منها، فحينئذ يرد عليها ويبين للناس الحق فيها، فهو استثناء وليس أصلا، وله ضوابطه، ويراعى فيه المصالح والمفاسد.
وصلَّى الله وسلم على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) قواعد وضوابط منهجية للردود العقدية، أحمد قوشتي (1/ 15).
([2]) العواصم من القواصم ت: عمار الطالبي (ص: 80).
([5]) درء تعارض العقل والنقل (7/ 182).
([6]) ينظر: الإتقان للسيوطي (1/ 68).
([7]) أخرجه البخاري (52)، ومسلم (1599).
([8]) ينظر: ذم التأويل لابن قدامة (ص: 31).
([9]) ينظر: ذم التأويل لابن قدامة (ص: 33).
([11]) أخرجه الدارمي (1/ 252)، والآجري في الشريعة (1/ 483)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 702).
([13]) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/ 137).
([14]) ينظر: ذم الكلام وأهله للهروي (4/ 348).
([15]) ينظر: مسائل أحمد برواية الخلال (7/ 9).
([16]) ينظر: شرح السنة للبغوي (1/ 227).
([17]) شرح العقيدة الأصفهانية (ص: 60).
([18]) مختصر الصواعق المرسلة (ص: 180-181).
([19]) الإبانة الكبرى (2/ 470).
([20]) بيان تلبيس الجهمية (3/ 510).
([22]) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/ 231).
([23]) مجموع الفتاوى (28/ 231).
([24]) الشريعة للآجري (1/ 455).
([25]) الرد على الجهمية (ص: 32).
([27]) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (ص: 60).
([28]) جامع بيان العلم وفضله (2/ 938).
([29]) درء تعارض العقل والنقل (8/ 88).
([30]) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 19) بتصرف يسير.
([31]) مفتاح دار السعادة (1/ 395).
([32]) الأنوار الكاشفة (ص: 34).
([33]) ينظر: قواعد وضوابط منهجية للردود العقدية، أحمد قوشتي (1/ 119، 135).
([34]) ينظر: قواعد وضوابط منهجية للردود العقدية، أحمد قوشتي (1/ 62).
المصدر: مركز سلف للبحوث والدراسات الإسلامية
 نصرة السنة موقع آخر في مكتب السنة
نصرة السنة موقع آخر في مكتب السنة